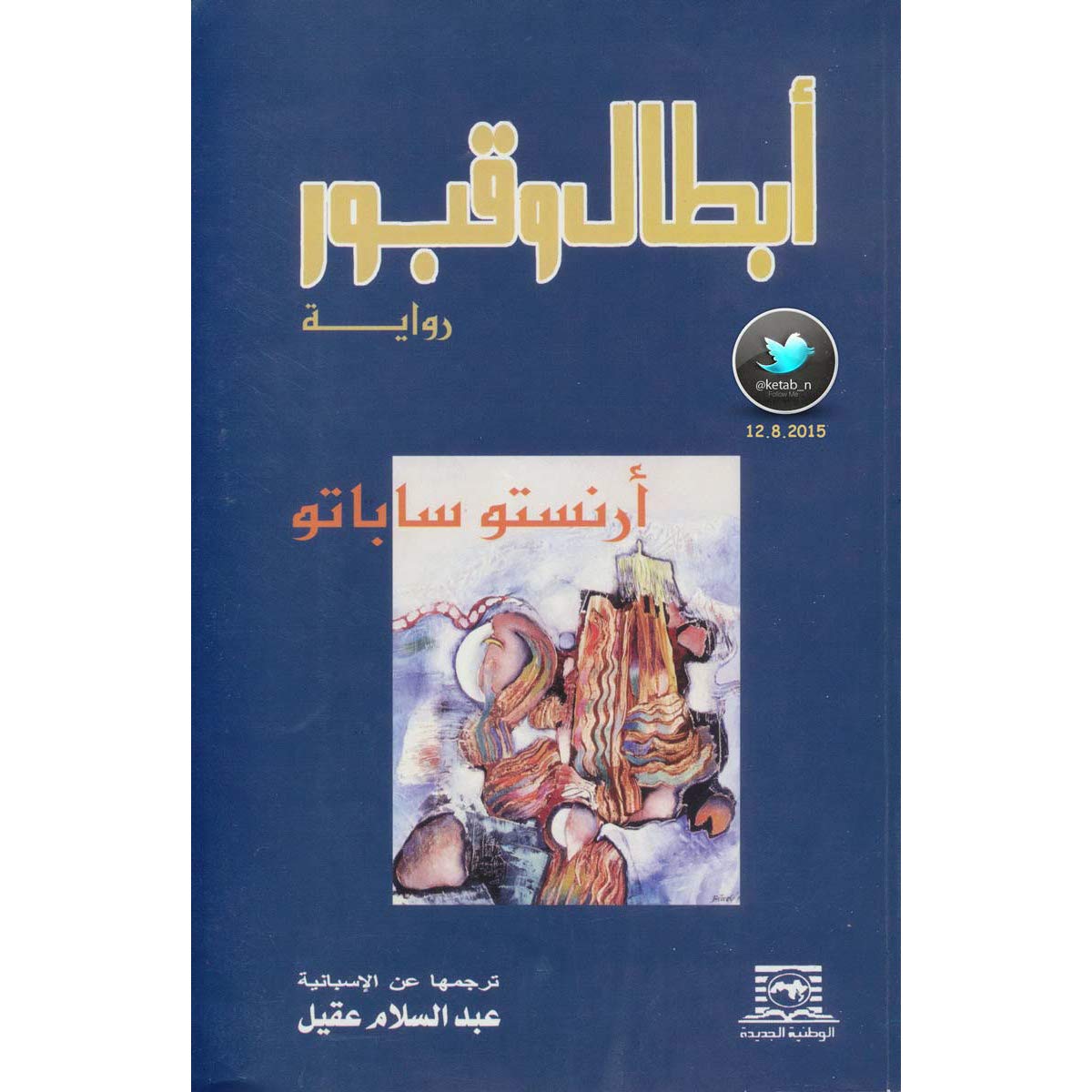
تحديداً عند الصفحة 372 من الطبعة العربية الثانية المنقحة عام 2004، تقدم لنا الرواية في المقطع الذي يحمل عنوان: “تقرير عن العميان” مناقشة حادّة تجري بين فرناندو – وهو رجل يعاني من الوسواس وهو يراقب البوابة 57، التي يختفي خلفها أحد العميان – وبين امرأتين عصريتين.
بداية المقطع
أعتقد أن الضغينة التي تكنُّها لي نورما حدتها على أن تأتي في أحد تلك الأيام، مع كائن خُنثَويّ يدعى إينيس غونسالس إيتورات، امرأة ضخمة وقوية جدا، نما شعر شاربيْها، وغطى الشيب رأسها، ترتدي ثوبا مفصلا عند خياط، وتنتعل حذاء رجل. ولولا ثدياها الهائلان، لأمكن، لمن يراها فجأة، أن يرتكب خطأ مناداتها: يا سيد. لكنها، مع ذلك نشيطة، وقوية، وتسيطر على نورما سيطرة تامة.
قلت:
– أتخيل أنني أعرفك.
– أنا…؟
سألتْ غاضبة، كأن في الأمر ما يشينها، ومن الطبيعي أن تكون نورما قد حدثتها عني كثيرا.
كنت أخال في الواقع أنني رأيتها في مكان ما، ولكن ما إن انتهى ذلك اللقاء المزعج (كنت مضطرا إلى مراقبة المبنى 57 خلف جسمها الضخم) حتى توضح لي ذلك الالتباس البسيط.
كشفت نورما عن رغبة مضطرمة بأن يحدث ما يشبه الجدال:
هزائمها المتكررة معي، جعلتها تتطلع، يحدوها أمل الانتقام، إلى فكرة القيام بمناقشة حادة مع ذلك العالِم الذرّي (تهزأ بي). ولكنني كنت منصرفا إلى أمر آخر، لا أستطيع معه أن أنأى بانتباهي عن الرقم 57 ولا ينبغي أن أفعل ذلك، لذا لم أُبْدِ أيّ اهتمام للانجرار إلى محاجّة مع تلك البضاعة، كان يتعذر عليّ أن أنهض لسوء الحظ، في مناسبة أخرى.
كان صدر نورما يرتفع ويهبط كالكير، وقدمت لي المرأة الضخمة وهي تقول:
– كانت إينيس معلمتي في مادة التاريخ كما سبق وقلت لك.
فقلت مجاملا:
– نعم.
– إننا مجموعة متكاتفة من الفتيات، وهي موجهتنا.
قلت أيضا:
– عظيم.
– ننتقد كتبا، نرتاد المعارض والمحاضرات.
– جيد.
– نقوم برحلات دراسية.
– هائل.
كان غضبها يتعاظم، وكاد سخطها ينفجر، وأردفت تقول:
– نقوم الآن بجولات نقدية على قاعات المعارض، معها ومع الأستاذ روميرو بريست.
حدجتني بنظرة يتطاير منها الشرر، وبينما كانت تنتظر تعليقا قلت بلهجة مهذبة:
– يا لها من فكرة حسنة.
فأردفت تقول بصوت كاد يكون صراخا:
– إنك تعتقد أن النساء يجب أن ينصرفن إلى تنظيف البلاط، وغسل الأطباق والاهتمام بالبيت فقط.
كان هناك رجل يحمل سلّما، بدا كأنه يود الدخول من الباب 57 ولكنه عندما تأكد من الرقم، مضى قدما إلى الباب التالي. وعندما هدأت أعصابي، رجوتها أن تكرر على مسمعي عبارتها الأخيرة التي لم أسمعها جيدا، فاستشاط غضبها وصاحت:
– طبعا…! بلغ الأمر حدا أصبحت معه لا تسمع. هذا يدل على مدى اهتمامك بآرائي.
– إني أهتم بها كثيرا.
– تبا لك من منافق…! قلت لي آلاف المرات إن النساء يختلفن عن الرجال.
– هذا مدعاة لأن أهتم بآرائك أكثر. يهتم المرء عادة بما هو مختلف أو مجهول.
– آه. تقر إذن بأنك تعتقد أن المرأة تختلف عن الرجل.
– يجب ألا يثيركِ أمر جليّ كهذا يا نورما.
قالت المرأة الضخمة، أو معلمة التأريخ التي كانت طيلة الوقت تتابع المشهد، فيما ترتسم على وجهها أمارات التهكم، ظنا منها أنني بلا شك من دعاة التجهيل:
– أتظن ذلك…؟
فسألتها متظاهرا بالسذاجة:
-أظن ماذا؟
قالت وهي تشدد على الكلمة:
-ذلك الأمر الجلي، الاختلاف بين الرجل والمرأة، أتظنه؟
فقلت بهدوء:
-إن جميع الناس متفقون على أن بين الرجل والمرأة تباينات أساسية.
قالت المربية وهي تداري غضبها خلف قناع هدوء كاذب:
-لا.. لا نعني هذا، وأنت تعرف تماما.
– هذا؟ ماذا تعنين بهذا؟
فقالت بلهجة قاطعة:
-الجنس، وأنت تعرف ذلك تماما.
بدت لهجتها كأنها سكين حادة، قاطعة ومعمقة. فسألتها:
-وتظنين أن ذلك أمرٌ لا يُعتدّ به؟
كنت منشرحا مستبشرا، وكانتا تخففان من وطأة انتظاري. ولكن ذلك الشعور الغامض بأنني رأيت معلمة التاريخ في مكان ما لم أتذكره، ظل يؤرقني.
– ليس الأهم طبعا! إنما نعني شيئا آخر. نقصد القيم الروحية، نقصد القيم الروحية بالتحديد. الاختلافات التي ترسخونها أنتم بين نشاط الرجل والمرأة سمات تقليدية لمجتمع متخلف.
قلت بهدوء:
– آه. لقد فهمت، تقصدين أن الاختلافات بين الفرج والقضيب هي من مخلفات (العصور المظلمة) وستختفي، جنبا إلى جنب، مع اختفاء الإنارة بالغاز، ومع اختفاء الأمية.
تضرجت المربية: لم تثر تلك الكلمات حفيظتها وحسب، بل خجلها أيضا، ولم يكن السبب مجرد لفظ كلمات مثل فرج وقضيب (وهما تعبيران علميان، لا يمكن أن يثيرا فيها سوى إحساس “محايد” أو “رد فعل تسلسلي”). سبب خجلها يعود إلى الآلية ذاتها التي تؤدي إلى امتعاض الأستاذ أينشتاين إذا ما سئل عن انتظام وظيفة أمعائه.
قالت بحزم:
– كلامك فارغ. الحقيقة أن المرأة في أيامنا هذه تزاحم الرجل في مختلف النشاطات، وهذا ما يثير سخطكم. تصور، وفد النساء الأمريكيات اللواتي وصلن مؤخرا: يضم ثلاث مديرات في حقل الصناعات الثقيلة.
عندما قالت المعلمة هذه الكلمة حدجتني نورما، ويا لها من أنثى، بنظرة انتصار، بكل ما أوتيت من ضغينة. كان ذلك الغولان يثأران، على نحو ما، من عبودية السرير. تطور صناعة التعدين في الولايات المتحدة، خفف إلى حد ما الصيحات التي كن يطلقنها في لحظات النشوة، ولطف من حدة استسلامهن المطلقة. موقف مهين، ولكن “البتروكيميا” الأمريكية أعادت الأمر إلى نصابه.
خاطر جانبي: صحيح: الآن وقد وجدتني مضطرا إلى العودة للصحف، تذكرت أني رأيت خبر وصول تلك الجوقة.
قلت:
– توجد نساء احترفن المصارعة أيضا. فهل ترضيكن هذه الوحشية؟
قالت المعلمة:
– تدعو وصول امرأة إلى عضوية مجلس إدارة شركة صناعية كبرى وحشية؟
ورأيتني، من جديد، مضطرا إلى التطلع من فوق كتفي الآنسة غونسالس إتورات الرياضيَّيْن، لرصد عابر اشتبهت به. وأثار هذا الحادث، الذي له ما يسوغه تماما، غضب تلك القميئة الموقّرة.
فقالت وهي تغمض عينيها بلؤم:
– ويبدو لك وحشية أيضا، تقدير عبقرية مثل مدام كوري، في ميدان العلم؟
وهنا كان لا بد مما ليس منه بدّ.
شرحت لها بهدوء، وجرس تعليمي:
العبقري هو الذي يكتشف هوية الوقائع المتناقضة، والعلاقات بين أحداث تبدو من حيث الظاهر متباعدة. هو من يكتشف عن الوحدة وراء التنوع، والواقع وراء المظهر، هو من يكتشف أن الحجر الذي يسقط في الفراغ والقمر الذي لا يسقط، كلاهما مظهران لظاهرة واحدة.
تابعت المربية حديثي بعينين ساخرتين، كمعلمة تستمع إلى طفل يهوى الكذب:
– وهل ما اكتشفته مدام كوري أمر يسير؟
– لم تكتشف مدام كوري يا آنسة قانون تطور الأجناس. خرجت ببندقية لاصطياد النمور، فعثرت على “ديناصور”، بمثل هذا المنطق سيكون عبقريا أيضا أول بحار وقعت عينه على مضيق “هورنوس”.
– بوسعك أن تقول ما يحلو لك. ولكن اكتشاف مدام كوري أدى إلى ثورة في ميدان العلم.
– إن خرجتِ يا آنسة لصيد النمور وعثرت على “قنطورس” [القنطورس كائن خرافي نصفه رجل ونصفه فرس]، فإنك ستثيرين أيضا ثورة في علم الحيوان، ولكن ما يثيره العباقرة ليس هذا النوع من الثورات.
– هل العلم محرّم على المرأة برأيك؟
– لا، ومتى قلت ذلك؟ ثم، إن الكيمياء مثلا تشبه الطبخ.
– والفلسفة؟ لا شك أنك تحظر على الفتيات الانتساب إلى كلية الفلسفة والآداب.
– لا، ولماذا؟ إنهن لا يسئن إلى أحد. ثم إنهن يعثرن هناك على عرسان ويتزوجن.
– والفلسفة؟
– ليدرسنها إن رغبن، فلن تضيرهن. كما أنها في الواقع لن تنفعهن، إنها لن تقدم ولن تؤخر، وليس هناك أي خطر من أن تحولهن إلى فيلسوفات أبدا.
صرخت الآنسة غونسالس إيتورّات:
– المشكلة أن هذا المجتمع السخيف لا يوفر لهن فرصا متكافئة مع الفرص التي يوفرها للرجال.
– كيف؟ إن كنا نقول إن أحدا لا يمنعهن من دخول كلية الفلسفة، ثم: قيل لي إن تلك الكلية تغص بالنساء. لا أحد يمنعهن من ممارسة الفلسفة، ولم يمنعهن من التفكير في منازلهن، ولا خارجها. وكيف يمكن منع إنسان من التفكير؟ والفلسفة لا تحتاج إلى أكثر من رأس ورغبة في التفكير. والآن، يكن لأي مجتمع أن سواء في العصر الإغريقي أو في القرن الثلاثين، أن يمنع امرأة ما من نشر كتاب فلسفي: بالسخرية أو المقاطعة، أو بأي وسيلة أخرى. ولكن أن يمنعها من التفكير؟ كيف يمكن لأي مجتمع أن يعرقل فكرة العالم الأفلاطوني في رأس امرأة؟
فانفجرت الآنسة غونسالس إتورات تقول:
– لو كان الناس على شاكلتك، لما تمكن هذا العالم من أن يتقدم!
– ومن أين أتيت بفكرة أن العالم يتقدم؟
قالت وهي تبتسم بازدراء:
– طبعا، والوصول إلى نيويورك خلال عشرين ساعة ليس تقدما!
– لست أدري. لا أرى فضيلة في الوصول بسرعة على نيويورك، فكلما تأخر المرء كان أفضل. ثم، كنت أظن أنك تعنين التقدم الروحي، ألم تقولي ذلك؟
– كلاهما يا سيدي. فالطائرة ليست سوى رمز التقدم العام الذي يشمل أيضا القيم الوجدانية. لن تقول لي يا سيد، إن البشرية لا تتمتع الآن بأخلاق أسمى من أخلاق مجتمع الرق.
– آه! إنك تفضلين العبيد بالراتب.
– يسهل على المرء أن ينظر إلى الأمور نظرة استهتار. ولكن أي إنسان سليم الطوية، يعلم أن العالم يعرف اليوم قيما أخلاقية كانت في القديم مجهولة.
– صحيح. فهمت. “لاندرو” الذي يستخدم القطار في أسفاره أسمى من “ديوجين” الذي يستخدم قاربا بدائيا.
– إنك تختار عامدا، أمثلة مضحكة. ولكن الأمر واضح رغم أنفك.
– قائد معسكر “بوتشينوالد” الألماني أسمى من قائد قافلة عربات تجرها الخيول، والقضاء على الحشرات البشر بقنابل النابالم أفضل من استخدام القوس والسهام. قنبلة هيروشيما خير من معركة بواتيه؟ التعذيب بالمهماز الكهربائي أكثر تقدمية من التعذيب بالفئران على الطريقة الصنيية؟
– تلك ليست سوى حجج واهية تمثل وقائع محدودة، والإنسانية ستتجاوز هذه الأعمال الهمجية أيضا. وينبغي أن ينحسر الجهل في نهاية الأمر عن كل المجالات أمام العلم والمعرفة.
قلت بهدوء ينطوي على نية شريرة:
– التعصب الديني أقوى حاليا مما كان عليه في القرن التاسع عشر.
– سيتراجع الجهل في النهاية، مهما كان نوعه، ولكن مسيرة التقدم لا بد أن تواجه بعض العراقيل والانحرافات. ذكرت سيادتك منذ لحظات، نظرية الارتقاء: إنها مثال على ما للعلم من قدرة على مواجهة جميع الأشكال الخرافية الدينية.
– إني لا أرى الآثار الساحقة لتلك النظرية. ألم نتفق على أن موجة الروح الدينية تتعاظم؟
– ذلك يعود إلى أسباب أخرى. ولكن النظرية قضت على كثير من الأضاليل قضاء مبرما، مثل تلك التي تقول بخلق العالم في ستة أيام.
– يا آنسة: إذا كان الله قادرا على كل شيء، فما الذي يضيره إن خلق العالم في ستة أيام، ووزع بعض الهياكل العظمية المنقرضة هنا وهناك، لكي يمتحن إيمان البشر أو بلاهتهم؟
– هيا..! لا أعتقد أنك تحاول إقناعي بجدية حديثك عن هذه المغالطة. ثم، إنك منذ لحظة كنت تطري العبقري الذي اكتشف نظرية الارتقاء، لكنك الآن تهزأ من تلك النظرية.
– أنا لا أهزأ منها، ولكنني أقول ببساطة إنها لا تثبت عدم وجود الله، ولا تدحض خلق العالم في ستة أيام.
– لو كان الأمر متروكا لك لما كانت المدارس موجودة، لا شك أنك من أنصار الأمّيّة.
كانت شتبه إلى حد بعيد ذلك الكائن البشري الفظ الشرس الذي كان يُلقي من منطاد منشورات تؤيد حق المرأة في التصويت، في فيلم (السبعة المحكومون بالإعدام)
– كان الألمان في 1933 من أكثر شعوب العالم تعلما. لو لم يكن الناس يعرفون القراءة لما تمكنت الصحف والمجلات من أن تزيدهم بلاهة على بلاهتهم، يوما بعد يوم. ولكن لسوء الطالع، حتى لو كان الناس أميين، فهناك عجائب أخرى سوف تدفعهم للتقدم، للأسف: الراديو والتلفزيون. كان يجب استئصال آذان الأطفال واقتلاع عيونهم، ولكن ذلك يحتاج إلى برنامج أصعب.
– برغم المغالطات، ستكون الغلبة دائما للنور على الظلام، وللخير على الشر. الجهل هو الشر بعينه.
– حتى الآن يا آنسة ، كانت الغلبة للشر على الخير دائما.
– مغالطة أخرى. من أين تأتي بمثل هذه الشنائع؟
– لم آت بشيء من عندي قط يا آنسة: إنه البرهان التاريخي الثابت، افتحي تاريخ “أونكن” على أي صفحة، ولن تعثري إلا على حروب، وإعدامات، ومؤامرات، وتعذيب، وانقلابات، ومطاردات. ثم إن كانت الغلبة للخير دائما، فلماذا ينبغي الوعظ به؟ وإن لم يكن الإنسان بطبيعته ميالا للشر، فلماذا يحرم عليه ارتكابه؟ ولماذا يوصم به؟ فكّري: إن أسمى الديانات تعظ بالخير. بل وأكثر من ذلك: إنها تملي وصايا، تطالب المرء بألا يزني. ولا يقتل، ولا يسرق، تفرض التقيد بها، كما أن قدرة الشر هائلة جدا. فهو يجعلنا نستخدمه للتبشير بالخير: يهددوننا، إن لم نفعل كذا أو كذان بأن الجحيم سيكون مصيرنا.
فصاحت الآنسة غونسالس إيتورات تقول:
– رأيك إذن، أنه يجب الوعظ بالشر؟
– لم أقل ذلك يا آنسة: جل ما في الأمر أنكِ تحمستِ جدا، ولم تستمعي إليّ. لا ينبغي الوعظ بالشر: الشر يأتي وحده.
– ولكن ماذا تريد أن تثبت؟
– لا تثوري يا آنسة، لا تنسي أنك تؤيدين نظرية تفوّق الخير، وأرى أنك تودين أن تقطعيني إربا. أود أن أقول بكل بساطة، إن ذلك التقدم الروحي ليس موجودا بل يجب أن نتأكد حتى من حقيقة وجود التقدم المادي الشهير أيضا.
شوّهت تصعيرة سخرية شكل شاربي المربية:
– آه، ستثبت لي الآن أن إنسان اليوم يعيش أسوأ من إنسان الأمس.
– الأمر يتوقف على الأحوال. فأنا لا أعتقد، مثلا، أن شيطانا مسكينا يشتغل ثماني ساعات يوميا، في فرن الصهر الذي يعمل بنظام المراقبة “الإلكترونية”، سيكون أسعد حالا من راعٍ إغريقيّ. ثلثا سكان الولايات المتحدة، فردوس الماكنة، مصابون باضطرابات عصبية.
– يسرني أن أعلم ما إن كنت تفضل السفر في عربة تجرها الخيول، على السفر في القطار.
– طبعا. كان السفر في العربة أمتع، وأكثر اطمئنانا. وعندما كان على ظهور الجياد كان أفضل: يتمتع المرء بالهواء الطلق والشمس، ويتأمل الطبيعة بهدوء. زعم حواريو الآلة، أنها ستوفر للإنسان يوما بعد يوم أوقات فراغ أطول. ولكن الحقيقة أن وقت الإنسان يضيق أكثر فأكثر، وهو يسير كل يوم بجنون أكبر. وحتى الحرب كانت في الماضي جميلة ومسلية، وفيها رجولة، وجاذبية: بتلك الأزياء المزركشة، بل لقد كانت صحية، فكّري مثلا بحربنا من أجل الاستقلال وبرحبنا الأهلية: فمن لم تصبه طعنة رمح أو لم يُقطع رأسه، إن بوسعه أن يعيش بعد ذلك مائة عام، كما حدث لجدي الأكبر أولموس. طبعا: حياة الهواء الطلق، والنشاط، وامتطاء الخيول. كانوا يرسلون الفتى الهزيل إلى الحرب لكي يشتد عوده.
نهضت الآنسة غونسالس إيتورّات غاضبة وقالت لتلميذتها:
– أنا ذاهبة يا نورما. وأنت ستعرفين ما ينبغي أن تفعلي.
ثم انصرفت.
ونهضت نورما أيضا يتطاير الشرر من عينيها، وقالت وهي تتوارى:
– تبا لك من فظ مستهتر…!
طويت جريدتي، وانصرت إلى مراقبة الرقم 57، لا يعيقني الآن جسم المربّية الهائل.
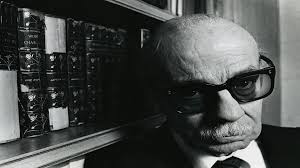
بينما كنت في تلك الليلة جالسا في المرحاض، في تلك الحالة التي تتراوح بين العضوية المرضية، والغيبية الماورائيّة، أبذل جهدا من جهة، وأتأمل في الوقت ذاته المعنى العام للعالم، كما يحدث عادة في هذا الجزء الفلسفي الوحيد من المنزل، أدركت في نهاية المطاف سبب تلك الحالة من اعتلال الذاكرة التي كانت تؤرقني في أول اللقاء: لا، لم أرَ الآنسة غونسالس إيتورّات من قبل، لكنها كانت شتبه إلى حد بعيد ذلك الكائن البشري الفظ الشرس الذي كان يُلقي من منطاد منشورات تؤيد حق المرأة في التصويت، في فيلم (السبعة المحكومون بالإعدام).
انتهى المقطع،،،